 وكنت وأنا في ذلك القمقم الزجاجي أرى ما حولي ولا أستطيع الحركة. رأيت قماقم كثيرة من حولي وأطيافاً محبوسين. ورأيت الشعب المرجانية والأسماك الملونة تسبح في حرية وهي تحاول الاقتراب من تلك القماقم ولكنها لا تقدر أن تلمسها فقد كانت محروسة بتعاويذ أولئك الجنود. وكنت أدرك أنه لا فكاك من هذا القمقم إلا بإحدى طرق ثلاث: أن يعفو عني النبي «سليمان» فيأمرهم بإخراجي، ولكن ذلك أمر مستبعد فقد فعلت أشياء تشيب لها الولدان وكنت أستحق القتل عن جدارة لقاء ما فعلت، أو أن تنقضي الفترة التي قدر فيها عقابي ولم أكن أعلم كم هي تلك الفترة، فقد تكون سنة واحدة أو عشرة آلاف، أو أن يموت النبي «سليمان» فيبطل الختم الذي تم وضعه على فوهة ذلك القمقم. وبقيت أنظر وأنتظر وأتأمل أن يحدث أحد تلك الأمور. وانقضى اليوم الأول كئيباً وكأنه ألف عام، وكأن تلك الشمس قد تسمرت في أفق السماء تأبى أن تتحرك نحو المغيب، وكأنها وقفت لتراقبني وتراني في قاع البحر فتشمت بي وتهزأ مني. وبعد أن شارفت نفسي على الهلاك رضيت تلك الشمس أن تتوارى وراء الأفق بعد أن شفت غليلها مني فغاب ضوؤها وحل الليل، وغاب معها أملي في أن يعفو عني النبي «سليمان» في تلك الليلة. وقبل أن أدرك مجيء الظلام أشرقت الشمس مرة أخرى في اليوم التالي وعادت بإطلالتها الساخرة وبقيت في كبد السماء، ثم غابت ثم أشرقت ثم غابت. وتكرر المشهد حتى أصبح رتيباً مثل انهيار المضارب من أيدي الموقعين فوق الطبول النحاسية. ما إن يرتفع مضرب حتى يقع الآخر ويظل النحاس يرزم بالأصوات المتكررة الرتيبة التي لا تنقطع ولا تتوقف ليل نهار. واستسلمت لهذه الحال وتوقفت عن المقاومة في انتظار ما تأتي به الأيام. ومع مرور الزمن غاب ذلك الترقب والأمل في نفسي، وخبا ذلك الغضب في قلبي، وانحسرت تيارات العداء، وحل محلها لوم وتأنيب ضمير ومراجعة نفس وتفكير طويل فيما فعلته ثم تأمل ونظر فيما حولي. البحر يعينك على هذا فهو هناك مهما مرت الأزمان وتعاقبت الدهور. الماء من حولك ومن فوقك ومن أسفل منك، والأسماك تذهب وتجيء، وقد يذهب البعض منها ثم لا يجيء أبداً بل يجيء غيرها. القمقم الذي سجنت بداخله شهد أحداثاً كثيرة حوله. فقد سكن تحته الأخطبوط وحامت حوله وفوقه الأسماك والقروش، واتخذته كثير من مخلوقات البحر مأوى لها تربض تحته، وحملته تيارات الماء في أحيان أخرى فلعبت به كثيراً وانتقل معها جيئة وذهاباً. وكانت الرمال تغمره وتغطيه فلا أرى شيئاً تحت ذلك الركام ثم لا تلبث المياه أن تنحت تلك الرمال فيخرج القمقم وأتمكن من الرؤية مجدداً.
وكنت وأنا في ذلك القمقم الزجاجي أرى ما حولي ولا أستطيع الحركة. رأيت قماقم كثيرة من حولي وأطيافاً محبوسين. ورأيت الشعب المرجانية والأسماك الملونة تسبح في حرية وهي تحاول الاقتراب من تلك القماقم ولكنها لا تقدر أن تلمسها فقد كانت محروسة بتعاويذ أولئك الجنود. وكنت أدرك أنه لا فكاك من هذا القمقم إلا بإحدى طرق ثلاث: أن يعفو عني النبي «سليمان» فيأمرهم بإخراجي، ولكن ذلك أمر مستبعد فقد فعلت أشياء تشيب لها الولدان وكنت أستحق القتل عن جدارة لقاء ما فعلت، أو أن تنقضي الفترة التي قدر فيها عقابي ولم أكن أعلم كم هي تلك الفترة، فقد تكون سنة واحدة أو عشرة آلاف، أو أن يموت النبي «سليمان» فيبطل الختم الذي تم وضعه على فوهة ذلك القمقم. وبقيت أنظر وأنتظر وأتأمل أن يحدث أحد تلك الأمور. وانقضى اليوم الأول كئيباً وكأنه ألف عام، وكأن تلك الشمس قد تسمرت في أفق السماء تأبى أن تتحرك نحو المغيب، وكأنها وقفت لتراقبني وتراني في قاع البحر فتشمت بي وتهزأ مني. وبعد أن شارفت نفسي على الهلاك رضيت تلك الشمس أن تتوارى وراء الأفق بعد أن شفت غليلها مني فغاب ضوؤها وحل الليل، وغاب معها أملي في أن يعفو عني النبي «سليمان» في تلك الليلة. وقبل أن أدرك مجيء الظلام أشرقت الشمس مرة أخرى في اليوم التالي وعادت بإطلالتها الساخرة وبقيت في كبد السماء، ثم غابت ثم أشرقت ثم غابت. وتكرر المشهد حتى أصبح رتيباً مثل انهيار المضارب من أيدي الموقعين فوق الطبول النحاسية. ما إن يرتفع مضرب حتى يقع الآخر ويظل النحاس يرزم بالأصوات المتكررة الرتيبة التي لا تنقطع ولا تتوقف ليل نهار. واستسلمت لهذه الحال وتوقفت عن المقاومة في انتظار ما تأتي به الأيام. ومع مرور الزمن غاب ذلك الترقب والأمل في نفسي، وخبا ذلك الغضب في قلبي، وانحسرت تيارات العداء، وحل محلها لوم وتأنيب ضمير ومراجعة نفس وتفكير طويل فيما فعلته ثم تأمل ونظر فيما حولي. البحر يعينك على هذا فهو هناك مهما مرت الأزمان وتعاقبت الدهور. الماء من حولك ومن فوقك ومن أسفل منك، والأسماك تذهب وتجيء، وقد يذهب البعض منها ثم لا يجيء أبداً بل يجيء غيرها. القمقم الذي سجنت بداخله شهد أحداثاً كثيرة حوله. فقد سكن تحته الأخطبوط وحامت حوله وفوقه الأسماك والقروش، واتخذته كثير من مخلوقات البحر مأوى لها تربض تحته، وحملته تيارات الماء في أحيان أخرى فلعبت به كثيراً وانتقل معها جيئة وذهاباً. وكانت الرمال تغمره وتغطيه فلا أرى شيئاً تحت ذلك الركام ثم لا تلبث المياه أن تنحت تلك الرمال فيخرج القمقم وأتمكن من الرؤية مجدداً. وشهدت حطام السفن الغارقة وجيف الموتى الذين ألقى بهم قتلتهم في المياه، وتسابق الأسماك لتفتك بتلك الأجساد الميتة قبل أن تتركها عظاماً ورأيت جيف الحيوانات الغارقة واجتماع جيوش الأسماك حولها تنهش من تلك الولائم السهلة. ثم بمضي الزمان وتتالي الأيام وتوالي العقود والعهود ساد المكان سكون أبدي وساد قلبي سلام داخلي واستسلام كامل ولامبالاة بما يحدث من حولي، وشهدت أجيالاً متعاقبة من الأسماك وحيوانات البحر، تولد وتموت وتجيء أجيال بعدها ثم ما تلبث تلك الأجيال أن تنقرض وتستمر دورات الحياة.. لم أتمكن من حساب الأيام لأن وسيلة الحساب عندي كانت طلوع الشمس وغروبها، وحين غاص ذلك القمقم عميقاً وطمرته نباتات البحر ورمالها غاب ضوء الشمس وما عدت أميز مجيء الليل ولا طلوع النهار، وتساوت عندي الساعات والأيام والشهور والسنين حين تساوى الليل والنهار. وكنت أقدر الزمان بساعتي الداخلية بين جوانحي تقديراً.. الحاسة الوحيدة التي توهمت أنها بقيت عندي هي حاسة السمع، رغم أنني ماكنت أقدر أن أسمع شيئاً خارج جدران القمقم. ولكن حين تتعطل جميع حواسك تصبح أنت والأموات سواء. كنت أتوهم أنني أسمع همهمات الأمواج وهي تلثم جدران القمقم الخارجية، وحركة الأسماك التي تلامسه، ودبيب الكائنات الدقيقة على الرمل وحركة حبيبات الرمل تحت تلك الأقدام الصغيرة في القاع هي سلوتي الوحيدة وعزائي لأتشبث بالحياة. كنت أعد حبات الرمل فأحسب كم حبة رمل تحركت اليوم أو أتوهم ذلك، وكم من الكائنات الدقيقة تسلق جدران ذلك القمقم من الخارج. وبقيت الأحلام هي متعتي الوحيدة في ظلمات البحر وتحت الرمل. وصنعت لنفسي عوالم كثيرة من الوهم الجامح والخيالات العجيبة والأحلام الغريبة، وكنت أنتقل لأعيش فيها كيفما يحلو لي، وصنعت لنفسي أصدقاء من الوهم والخيال فكنت ألعب معهم أحياناً وأتشاجر معهم كثيراً وأتنقل معهم بين الأزمنة والأماكن. أصنع القصور الوهمية ثم أغضب لأشن عليها الحروب وأهدمها. وأحياناً أتمثل نفسي أميراً ساحراً وأحياناً ملكاً جباراً، أو أتحول لأصير فتاة جميلة أو ساحرة عجوزاً مشئومة، أو أتخيل نفسي قندساً يسبح في الماء أو عصفوراً يطير حراً في الهواء ويحلق في أفق الفضاء.
وشهدت حطام السفن الغارقة وجيف الموتى الذين ألقى بهم قتلتهم في المياه، وتسابق الأسماك لتفتك بتلك الأجساد الميتة قبل أن تتركها عظاماً ورأيت جيف الحيوانات الغارقة واجتماع جيوش الأسماك حولها تنهش من تلك الولائم السهلة. ثم بمضي الزمان وتتالي الأيام وتوالي العقود والعهود ساد المكان سكون أبدي وساد قلبي سلام داخلي واستسلام كامل ولامبالاة بما يحدث من حولي، وشهدت أجيالاً متعاقبة من الأسماك وحيوانات البحر، تولد وتموت وتجيء أجيال بعدها ثم ما تلبث تلك الأجيال أن تنقرض وتستمر دورات الحياة.. لم أتمكن من حساب الأيام لأن وسيلة الحساب عندي كانت طلوع الشمس وغروبها، وحين غاص ذلك القمقم عميقاً وطمرته نباتات البحر ورمالها غاب ضوء الشمس وما عدت أميز مجيء الليل ولا طلوع النهار، وتساوت عندي الساعات والأيام والشهور والسنين حين تساوى الليل والنهار. وكنت أقدر الزمان بساعتي الداخلية بين جوانحي تقديراً.. الحاسة الوحيدة التي توهمت أنها بقيت عندي هي حاسة السمع، رغم أنني ماكنت أقدر أن أسمع شيئاً خارج جدران القمقم. ولكن حين تتعطل جميع حواسك تصبح أنت والأموات سواء. كنت أتوهم أنني أسمع همهمات الأمواج وهي تلثم جدران القمقم الخارجية، وحركة الأسماك التي تلامسه، ودبيب الكائنات الدقيقة على الرمل وحركة حبيبات الرمل تحت تلك الأقدام الصغيرة في القاع هي سلوتي الوحيدة وعزائي لأتشبث بالحياة. كنت أعد حبات الرمل فأحسب كم حبة رمل تحركت اليوم أو أتوهم ذلك، وكم من الكائنات الدقيقة تسلق جدران ذلك القمقم من الخارج. وبقيت الأحلام هي متعتي الوحيدة في ظلمات البحر وتحت الرمل. وصنعت لنفسي عوالم كثيرة من الوهم الجامح والخيالات العجيبة والأحلام الغريبة، وكنت أنتقل لأعيش فيها كيفما يحلو لي، وصنعت لنفسي أصدقاء من الوهم والخيال فكنت ألعب معهم أحياناً وأتشاجر معهم كثيراً وأتنقل معهم بين الأزمنة والأماكن. أصنع القصور الوهمية ثم أغضب لأشن عليها الحروب وأهدمها. وأحياناً أتمثل نفسي أميراً ساحراً وأحياناً ملكاً جباراً، أو أتحول لأصير فتاة جميلة أو ساحرة عجوزاً مشئومة، أو أتخيل نفسي قندساً يسبح في الماء أو عصفوراً يطير حراً في الهواء ويحلق في أفق الفضاء.



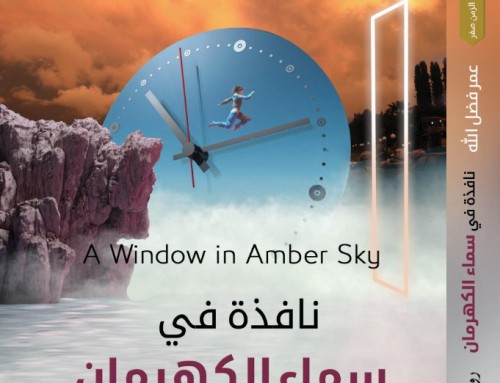
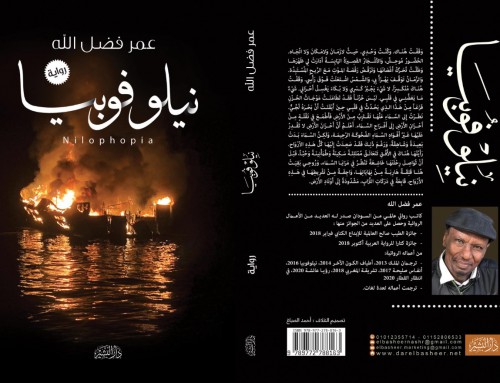

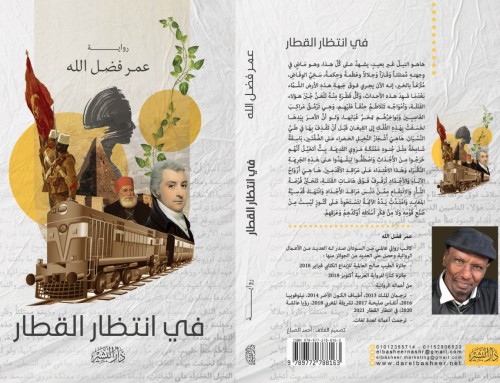



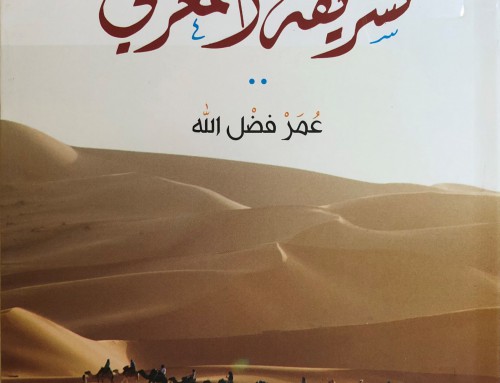










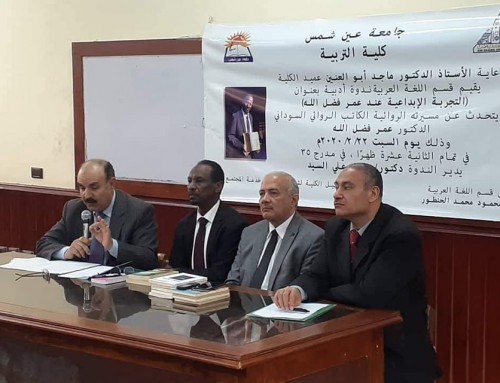









اضف تعليقا